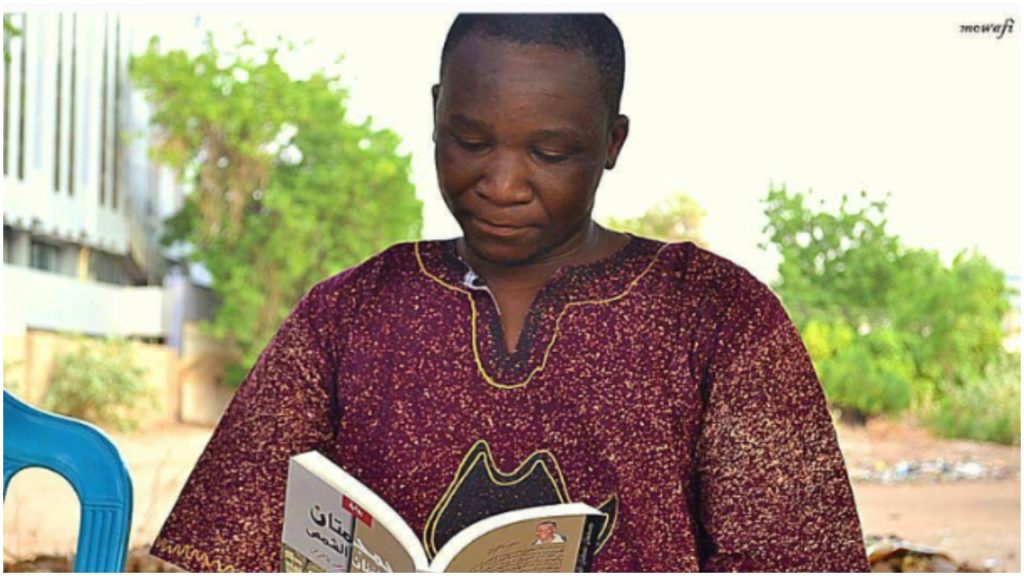هذا الحوار انه النزيف حينما يكون الطين مبتلا ،انه الصلصال الجاهز لتشكيل مخلوق خارج لتوه من رحم الحبر وفضائه،ليس حوارا عاديا ونمطيا كبقية الحوارات انه حوار موسمي ، كل ما هو سردي ومتخيل ومخاتل يقبع في ثنايا النص ،اللغة المطرزة بالحكي ، وتحالف الزمكان في فضاء الورق .
حاوره:احمد يعقوب
ما الذي دفعك للكتابة؟!
حسناً يا صاحب؛ أُنصت جيداً؛
“ثمة رجل طويل القامة، منسدل الشعر، يرتدي عمامة ملتفة حول رأسه بإحكام و جلباب ناصع البياض”
.. يظهر هذا الرجل الغامض يومياً منسلاً من الليالي المظلمة، داخل غرفة صغيرة، يظهر هكذا لفترات طويلة دون أن ينطق كلمة واحدة، كانت أمي في شهرها الأخير قبل مجيئي لهذا العالم، كلما دلفت للغرفة رأت الرجل المبهم الصامت دائماً، تصاب بالفزع و الخوف ثم تعود مهرولة نحو فناء البيت، لم يكن بإستطاعة أحد رؤية الرجل باستثناء أمي، يظل الرجل واقفاً قرب خزانة الملابس حتى منتصف الليل..و أحياناً حتى الفجر ثم بعد ذلك يختفي دون أن يترك أثر.
تقول أمي:
” إستمر الرجل المبهم في الظهور لمدة طويلة، ثم تحول من اليقظة للمنام، لفترة ليست بالقصيرة؛ يأتيني كل ليلة في المنام.. يملي علي أشياء معينة، يأمرني مثلاً بأكل أنواع معينة من الأطعمة، أو قراءة أوراد دينية في أوقات محددة أثناء اليوم، إلى أن جاءني للمرة الأخيرة.. كان نهاراً من نهارات الشتاء التي تجعلك تهذي من فرط كثافتها الموحشة، كنتُ أستلقي على سريري الحديدي خالي الوسادة على مقربة من الحائط الجنوبي للبيت، غفوتُ غفوة طارئة، زارني الرجل.. كان يتأبط دواة سوداء بجرة صغيرة..و قلم مصنوع من القصب، فيما كنتُ أنا جالسة على السرير في منامي أتابع بقلق ما يفعله، هبط لأسفل..وقف بمحاذاة عيناي.. رمقني بنظرة قوية، ربت على كتفي بحنان و قال: سأكتب لك شيئاً على القطعة المعدنية المستوية أسفل السرير.. أغسليها بالماء ثم اشربيها دفعة واحدة..فلن ترينني أبداً بعد اليوم.. لن أتراءى لك مرة أخرى..ثم طار للفضاء، صحوت خائفة، فعلاً وجدت القطعة المعدنية مليئة بالكتابة و الطلاسم..غسلتها كما أمرني.. ثم إكترعتها حتى تجشأت..و فعلاً لم أره بعد ذلك مطلقاً..”.
لاحقاً؛ في شتاء آخر أيضاً، و في السنة العاشرة بعد الميلاد؛ كنتُ الطفل الصغير الذي يلعب في الشارع الخلفي للبيت، كانت الشمس الشتوية تنزلق ببطء نحو مغيبها الشفقي، بردائي القصير، دراجتي الجميلة التي جلبها لي أبي في إحدى جولاته الغامضة الغريبة، سأرى في ذلك اليوم.. وفي غمرة اللهو و اللعب الطفوليين على أكتاف البراءة الإلهية العذراء، رأيتُ ظلاماً كثيفاً يسري من الجهة الجنوبية يغطي الكون كله، سرب من الطيور المحلقة تختبئ بفزع بين فروع الأشجار الكثيفة النائمة، هنيهة من الزمن..سرعان ما تضيء السموات كلها، ببروق عظيمة تضيء و تنطفئ، وفي الأديم الأرضي فلوات شاسعات خالية من المساكن، و بسفوح الأشجار موكب مهيب من مخلوقات غريبة بأجنحة تقيم قداساً جنائزياً بأصواتها ذات الأصداء المتداخلة، و أنا على دراجتي الصغيرة يصلبني الخوف و العرق و الحمى، كنتُ أقرب لشخص مصروع مصاب بالشلل و الكتاتونيا، رأسي مصلوب لأعلى، رأيت السماء تنفلق بطريقة جنونية، رأيت شقاً مخيفاً في الأعالي، تنقسم السماء لجهتين متباعدتين..فيما يظهر بين الفراغ السماوي رجل طويل القامة، منسدل الشعر، يرتدي عمامة ملتفة حول رأسه بإحكام و جلباب ناصع البياض، يحمل بيديه جرة
دواة صغيرة و قلم من القصب، أشار إلي بهما..إستضاء بقوة ثم إختفى. هل تصدق ذلك يا صديقي المحاور..؟!
حسناً ،ثم ماذا حدث بعد ذلك؟
أفقتُ من ذهولي..تركتُ دراجتي في العراء و ركضتُ بما يشبه الطيران للبيت. كانت أمي تجلس على آلة الخياطة تخيط ملابس كثيرة لا حاجة لأحد إليها، و ترمم ملابسنا الصغيرة التي مزقتها مشاغباتنا الطويلة اللانهائية، جريتُ نحوها و جسدي كله يرتعش و العرق يسيل بغزارة بأنحاء جسدي كلها، ارتميتُ على حجرها كمن أراد العودة غير الطوعية للرحم، تفرست وجهي فيما تسألني عن سبب فزعي لتلك الدرجة، أخبرتها بما حدث، أخبرتها عن الرجل الغريب الطويل الذي تجلى لي في سموات الله الغسقية الواسعة. تقول الأم: إنه نفس الرجل!
في السنة الثامنة عشر بعد الميلاد؛ سأكون ذات الفتى المليء بالأسئلة، الغارق في النفس و ملاحمها، المتسائل حد التفتت عن جدوى العالم و معناه، سأكون بطريقة ملتبسة الفتى المتورط في الكوابيس، الساري سريان الدم في البحث عن الإجابات و دوائرها، في ذلك الزمن المرتبك، زمن البلاهة الكلية و اليرقان النفسي، كنتُ ملبوساً برداء الوجود الممزق، منطوياً و منكفئاً على الذات بشراهة و أفكر كل ليلة على فراشي بإبتلاع جسدي و إشعال الحريق بالكرة الأرضية كلها، هو الزمن المؤكسد بثاني أكسيد الشتات و القلق، إذ يتراءى لي الرجل في المنام، اليقظة، تحت سرير النوم، فوق عارضات الأبواب، في السرحان، الإنشغالات الذهنية العابرة، السماء، الأرض، تحت الجلد، أسفل الخاصرة، و في رئتاي المليئتان بنترات الكربون. كنتُ حينها بالمرحلة الثانوية، أو في منتصفها للدقة، لا أنسى أبداً اليوم الذي كنتُ فيه بصالون البيت، في إحدى ليالي كسلا التي دائماً ما تصيب حنينك في مقتل، كنتُ مستلق على سريري، يجلس صديقي و رفيق طفولتي الأولى منذر صلاح الدين.. على أريكة خشبية يحدق بطريقة عشوائية في السقف، فيما أنا أقلب صفحات كراسة العلوم التجارية دون تركيز، شعرتُ بسريان كثيف للدم، تنميل مضطرب تحت لباسي الجلدي، دقات مرتبكة سريعة للقلب، ضيق في التنفس..ثم فقدت الوعي. رأيتُ الرجل الطويل، لم يكن وجهه مريحاً كما كان في الماضي، يرمقني بنظرة نارية ثم يرمي على صدري شيئاً له ملمس ورقي و رائحة نفاذة.. حاولتُ التقاط الأشياء التي رماني بها ..لكن جسدي كان ثقيلاً، مقيداَ، محاصراً بين قفص لامرئي و كأن كائناً أسطورياً عاث فساداً على تضاريس كتلتي الجسدية، أو كفريسة وقعت بشباك من سلاسل جهنمية عصية على الفكاك!
رأيتُ الناس يتجمهرون فوق رأسي، قالت أمي: كنت تهذي كالممسوس! في البداية ظننت أنه الموت. كان يوماً مفصلياً بحياتي، لأنني ببساطة لم أكن بعدها ذات البني آدم مطلقاً، هو اليوم الذي بدأت فيه خلايا الأسئلة تتناسل و تنبح كالكلاب السعرانة التي لا تمل المطاردة بأحراش جهازي النفسي، اليوم الذي انفجر فيه بركان القلق الوجودي دون رحمة، يوم الإشراق الروحاني الخام و انطلاق عجلة التدوين و الزواج غير المعلن بيني و بين الكتابة، في الأيام التالية ..أو في السنوات التالية؛ أخذ الرجل يتكرر في المجيء، يتراءى لي في المنام و في سرحانات اللحظات النهارية، يحكي لي أشياء، يأمرني بأشياء، و يصفعني بقوة على وجهي عندما أتململ أو أتذمر،وفي كل ليلة..على مدى خمس سنوات؛ أسمع وقع أقدام أمام غرفتي لشخص مجهول، و طرقعة أصابع، ضوء كيروسين ينثال أسفل الباب و فتحات النافذة الصغيرة، و ظلال لشخص مبهم رافعاً يديه لأعلى و هو على وشك الطيران، و أحياناً منحن و مقوس الظهر، و في أحايين أخرى أرى ظل للكائن البشري الغامض خلف باب غرفتي الموارب ماداً أصابعه للأمام على وشك الطرق، حينما أهم بمبارحة فراشي و الإقتراب يختفي الظل، و أسمع وقع أقدام جارية في المدرج، و ضرب سريع و متتالي على الدرابزين بالأصابع، حين أخرج لا أرى شيئاً، أرى ظلي مرمياً على المدرجات، و رأسي يدور بشكل عشوائي بالجدران، و قط مرقط يقف مذعوراً قرب سلة المهملات المنكفئة أسفل السلالم الحجرية.
الشيء الوحيد المخذي و الملعون حينها: أنه لا أحد يصدق ما يحدث، ولا أحد يستطيع تخيل هذه الترهات نهائياً، إلى أن جاء اليوم الذي قررتُ فيه تدوين هذه الأحداث و إفراغها على الورق، فعلاً؛ كتبتُ شيء لا أتذكره الآن عنونته: الرجل صاحب الظل . ومنذ ذلك الوقت..وجدتُ الطريق إلى رئتي، نما ريشي بإفراط، إستطالت أجنحتي، تمرنتُ طويلاً على التحليق و التنفس، زرعتُ بزرواً في تربة الروح في إنزياحاتها الأبدية، سكبتُ عليها الدم، غسلتها بحليب الشغف، و هأنذا اليوم..متجولاً حتى الموت في حدائق اللغة ، بساتينها ، مقابرها ، أنحاء المعتم في النفس و الإنسان، أغنياتها ، حقول الألغام الكامنة ، توابيت القلق العارم ، نشوة الحروف و هي تنسكب كالعسل ببطء، و دواب الغرائبيات الغامضة تفر من مخابئها العدمية الضابية و تغزو مفاتن الأخيلة..التي دائماً ما أعتبرها عروس الكتابة الأدبية. تقول أمي: لقد أورثتك ضلالاتي البصرية؛ آخر مرة رأيتُ فيها الرجل و الكوابيس كان قبل ولادتك بشهر واحد، هأنت الآن.. ملبوس بالكوابيس، باحثاً عن المعنى، و تنصب شراكك بصبر و أناة لأقتناص اللحظات الهاربة للكتابة..مباركٌ يا بني، لك الصلوات كلها.
كسلا؛ هي الفضاء المكاني الذي حدث فيه كل ذلك، المدينة التي شيعت طفولتي لمزارع الكوابيس، المدينة التي –وأنت فيها- يعتريك إحساس دائم بالإخضرار، مدينة الأشياء كلها: الصلوات الجماعية بعبقها الروحاني، عصير المحبة الحلو..الذي يوزعه المارة مجاناً على الطرقات، مدينة العناق العاطفي الطويل، البيوت السرية بباحة المساكن الخلفية، البنات ذوات السكسك ، عشائر الله كلها، أغانيها الشعبية الجليلة، الأمطار الموسمية الغزيرة، مدينة الشعوب التي إنحازت للحياة.. ثم باعت البؤس لنخاسي الموت العابرين بسرعة للأماكن.
الآن؛ و بعد كل ذلك أتساءل: هل تكتبنا الكتابة؟! ثم أتساءل: هل صدقتني يا صديقي المحاور؟! إحترس! فأنا لستُ متأكداً من كل القصص أعلاه، ربما لم تحدث مطلقاً، أنا كاتب، و كما تعلم؛ الكاتب هو المشروع الدائم للأكاذيب الجيدة، قد أكون أيضاً كاذب سيء يقول الكذب بطريقة مقبولة إجتماعياً. إذ يقول أحدهم: الكتابة: هي الشيزوفرينيا الوحيدة..المقبولة إجتماعياً! هل أنت معي؟!! بالمناسبة: كم مرة ذكرتُ كلمة الموت هنا!
اصدقك القول سببت لي روايتك جمجمتان تطفئان الشمس هلاوس واكتئاب ورعب كيف إستطعت تطويع الذاكرة البصرية للنص؟
هل هي الذاكرة فعلاً..أم البصيرة، رهاني دائماً على البصيرة و ليس البصر، فبالنسبة لقواميسي الخاصة الذاكرة هي محض خزانة لملابس البصر المستعملة، في الحالة الجيدة / التي تسمح للعين إنتخابها لاحقاً في ضرورات بصرية أخرى، هي أيضاً فكرة هيدروليكية / سيالة/ في إنزياحات ناجزة/ تنمو خارج جينات الجامد، الساكن و جثامين الأفعال الميتة، ففي ديانات الذاكرة المتفرعة؛ لا يوجد شيء ثابت مطلقاً، إذ تتواصل عملية التناسل البصري بشكل فسيفسائي داخل الذاكرة، ” نهاية العملية البصرية لا يعني إنتهائها..بل يعني المزيد من التوليد داخل الذاكرة” ، فمثلاً: كان جدي متصوفاً؛ إعتنق الطريقة التجانية كطائفة دينية هو رأى فيها مركبه للنجاة، صام تسعون عاماً متتالية، ثم مات في عمره العاشر بعد المائة و هو يصلي بفناء محرابه الضيق منتصف الليل. رأيتُ أبي مفزوعاً، بملابس النوم و حافي القدمين يهرول، يدخل المحراب و يخرج بطريقة أثارت كيمياء فضولي، في المرة الأخيرة دخل أبي المحراب و مكث طويلاً، بارحتُ فراشي و لملمت جسدي كله بحواف أصابع قدماي و ذهبت، سمعتُ أبي يبكي، كان نحيباً خافتاً و متقطعاً، فيما يقرأ تعازيم روحانية بصوت محمول على أكتاف العويل السري الذي يعلن عن نفسه بصعوبة لا تغفلها الأذن. لم يرني الأب حينما خرج-كان ذلك شيئاً ممتازاً-دلفتُ إلى باحة المحراب الضيق، رأيتُ فراء جدي المصنوع من صوف الماعز مفروش على الأرض، موضوع عليه كتُب دينية مختلفة، يعتليها قرآن بغلاف أحمر اللون و ورق أصفر جليل الرائحة، و على مقربة من الفراء إبريق فخاري ملفوف داخل قطعة جلدية مبتلة جديثاً..تشي برطوبة خارجة عن نطاق القانون اليباسي و عقائد الجفاف.
رأيتُ جثمان جدي مسجى على أريكة حجرية تسع جسد أقعدته السنوات الدينية و أكلت البروش التجانية سلاسله الفقرية الطويلة،كان الجثمان مغطى بقماش أخضر اللون، قماش المتصوفة باخضراره التاريخي، تنبعث منه روائح غريبة، نوع الروائح القوية التي تحيلك إلى زمن غابر في التاريخ البشري، التاريخ الذي أنت نفسك لم تكن يوماً جزء منه، لكن على أي حال؛ تجعلك دائماً تشعر أنك على وشك السقوط من فرط نفاذيتها و إختراقها فضاءك الرئوي، و في الحقيقة، قادتني قطط الفضول للإقتراب للجسد العجوز المغطى، أزحت الغطاء من الرأس، بدا لي وجهه أكبر من المعتاد، منتفخ، مضيء، مليئ بزغب شعر أبيض يحيل الوجه لوجه قديس مغتسل للتو بماء مقدس، و علامة صلوات غزيرة تقف بهية، عميقة، وواضحة بمقدمة رأسه الذي توقف فيه الدم عن السريان. وضعتُ يدي –بخوف-على صدره، لم يكن يتنفس أبداً، علمتُ حينها أن جدي الآن دون شك غادر العالم في صمت، دون زوبعة، أو ضجيج، و دون أي أثر داخل المحراب..على أي محاولة للمقاومة، عاش هادئاً، و مات دون أن يركل شيء بقدميه بينما يحتضر.